في المسألة الديمقراطية وشرعية الحكم

قبل الخوض في الموقف من الدعوات التي برزت في الأيام الأخيرة والمنادية بإطلاق جولة جديدة مما عرف باعتصام الرحيل وما رافقها من ردود فعل متضاربة ومتباعدة، أرى من اللزام التذكير ببعض الملاحظات المنهجية والمبادئ الأساسية التي من دونها قد نسقط في الأحكام الإطلاقية في هذا الاتجاه أو ذاك. صحيح أن الديمقراطية في عالم اليوم تعيش أزمة تمثيل وأزمة تطور وتأقلم مع المستجدات السريعة والمتغيرات الدولية ولم يعد خافيًا تعدد مظاهر أزمة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والعامة ومن أبرز آثارها انحسار دور الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة على حد السواء وعزوف عامة الناس عن الانخراط في العمل الحزبي و هجرتهم الأشكال التقليدية للمشاركة في الشأن العام وميلهم نحو أنماط جديدة أقل مركزية وبيروقراطية وأكثر مرونة وبالخصوص أكثر قرب من المواطن وعادة ما تعتمد فيها شبكات التواصل الاجتماعي والرقمنة.
ولهذه الأسباب فقد شهد مفهوم الديمقراطية تطورا ملحوظا وأصبح لا يقتصر فقط على شرعية صندوق الانتخاب وصارت شرعية الإنجاز والحصيلة هي الأساس. كما أصبح لتزكية وتأييد المجتمع المدني والإعلام والهياكل والمؤسسات الوسطى وما يسمى بالرأي العام او بالشارع دورا أساسيالإضفاء المشروعية والمصداقية وبالتالي البعد الديمقراطي على الأنظمة السياسية.
انتهى إذا عهد الشرعية الانتخابية وحدها او شرعية الحكم وحلت محلها شرعية الحزام السياسي الشعبي ومباركته للسلطة القائمة على خلفية نجاحها في القيام بالإصلاحات الضرورية. إن الشرعية الانتخابية لا تعني مصادرة حق المجتمع المدني في الاحتجاج الحر والمدني والسلمي لفرض التغيير المطلوب في السياسات وحتى في الحكومات وقد ينجر عنه تغييرا في المسار الانتخابي بما فيها تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها إذا ما سمحت به موازين القوى المتصارعة. قد يذهب إلى أذهان البعض إن مثل هكذا تفكير هو أقرب منه للانقلاب على الشرعية أي عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات. وهذا في اعتقادي يعكس فهمًا تقنيًا وقانونيًا وإجرائيًا للمسالة الديمقراطية تجاوزه الزمن. فقط على سبيل المثال لا الحصر كلنا يتذكر في أي ظروف سقط مشروع قانون العقد الأول للشغل في فرنسا في أفريل 2006 على الرغم من مصادقة البرلمان عليه إلا أن الاحتجاج السلمي التلمذي والطلابي والشعبي تمكن من الإطاحة به وإرغام السلطة على التراجع عليه نتيجة ميزان القوى الذي كان لصالح الشارع الفرنسي آنذاك.
والأمثلة عديدة ودون إن نقوم بالدعاية إليها فقط برزت في العالم المتقدم أصوات نخب فلسفية وفكرية وسياسية وان كانت لاتزال أقلية تدعو للعصيان المدني وعدم الانضباط للقوانين الجائرة والتمرد على الأنظمة التي تعتبرها لا تمثلها. يمكن الإشارة في هذا السياق للتجربة التي لا تزال تعيشها فرنسا بعد ما يزيد عن السنتين والمتمثلة في السترات الصفراء. وكذلك تجربة ما يعرف بحركة السردينة في إيطاليا كرد فعل عن تنامي التيارات الشعبوية في الحكم. وعلى هذا الأساس فإنه لا يجب التسرع في الحكم على هذه الدعوات بالسلب او بالإيجاب لأنها هي نفسها لم تكشف بالقدر الكافي عن هويتها وأغراضها.
فإذا ما تعلق الأمر بمبادرات سلمية هدفها التعبير على مواقفها من الوضع العام بالبلاد ومن السياقات السياسية الراهنة سواء تعلق الأمر بمسارات تشكيل الائتلاف الحاكم وكيفية إدارته لازمة الكورونا وطريقة تعامله بشؤون الدولة والمجتمع وأوضاع التونسيين فهذا في اعتقادي لا يتعارض ودستور البلاد وقوانينها. هذا على المستوى المبدئي بقطع النظر عن وجاهة اختيار التوقيت من عدمه. وقد يساهم هذا الحراك في عودة الروح للحياة السياسية ويحد من العزوف وهجرة الشأن العام. بقي على الذين تحمسوا لهذا الخيار ألا يصبون غضبهم على الأحزاب والشخصيات المتحفظة على توقيت هذا الحراك. ان تعدد المواقع قد يفرض تعدد المواقف وربما توزيع الأدوار داخل المؤسسات وخارجها. ليس من النضج ولا من المسؤولية تضخيم الخلاف بين معارضي الائتلاف الحاكم بمجرد خلاف في تقييم ضرورة أو عدم ضرورة الانطلاق في الحركات الاحتجاجية منذ اليوم.
وعلى المندفعين من أجل الإسراع بنصب الخيام والتجمعات وإعادة تنشيط الفضاء العمومي بنزول التونسيين إلى الشارع أن يتأكدوا من جاهزية المواطن واستعداده للانخراط في هذا الحراك. لان اي سوء تقدير لا يخدم قضاياهم العادلة والمشروعة. ومن جهة أخرى لا يمكننا إلا أن نستغرب ونستنكر السرعة الفائقة التي تميزت بها بعض أطراف الائتلاف الحاكم التي سارعت بإطلاق النار على مجرد تفكير أولي ودعوات أولية للنزول إلى الشارع والاحتجاج السلمي وهو مايكفله الدستور معبرة عن انعدام كامل للثقافة الديمقراطية وحق الاختلاف والتنظيم والتظاهر.
ومن نكد الدهر ان تصدر هذه المواقف من قوى وكتل نيابية محسوبة على الثورة والديمقراطية. ويبدو أن صعودها الى الحكم أفقدها صوابها وبدت عليها وفي خطاباتها مظاهر التسلط والهيمنة وحتى الفاشية. وللتذكير فإن أزمة الديمقراطية سابقة لأزمة فيروس كورونا وأكيد أنها ازدادت عمقا وبالتالي علينا ان نراجع أنفسنا ومفاهيمنا حتى نستطيع فهم واستيعاب المتغيرات الحاصلة في التفكير السياسي نتيجة التقلبات التي تشهدها الإنسانية.
وكلنا يتذكر كيف كان قرار حركة النهضة بالموقف من تقرير المساواة والحريات العامة وكيف صرحت كل قياداتها بانها تركت الموقف للشارع ولحشد الأنصار والمؤلفة قلوبهم والأذرع المتطرفة لإسقاط هذا الإصلاح وتكفير الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وشيطنة الهيئة ورئيستها. كما أنه علينا أن لن ننسى كيف حركت التيارات اليسارية المتطرفة بعض جمعيات المجتمع المدني ودفعها للنزول الى الشارع لمنع تمرير قانون المصالحة الإدارية. الفيصل هو الأسلوب والتوقيت والقدرات التعبوية ومشروعية المطالب. لا انقلابا ولاهم يحزنون. الموضوع إذا ما حافظ على سلميته وأهدافه النبيلة ولم يخرج عن اخلاقية التحركات الشعبية الأصيلة فهذا يبقى من الحقوق التي ضمنها دستور البلاد.
إن مثل هذه الدعوات للاحتجاج وحتى وان كان أفقها المطالبة بتغيير الحكومة او حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة هي منتظرة وتتكرر طالما تواصلت أزمة الحوكمة الرشيدة وتأخرت الإصلاحات الضرورية وتدهورت نوعية حياة التونسيين بمن فيها الفئات المهمشة والأكثر فقر أو الشرائح الاجتماعية التي تفقرت طيلة العشرية الماضية نتيجة للسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة. ان التعلل بمسالة الديمقراطية واحترام صناديق الاقتراع وانتظار المواعيد الانتخابية لا يستقيم من باب الديمقراطية نفسها وهو يعكس إرادة التمسك بالسلطة بكل الوسائل ومصادرة حقوق الشعوب في التغيير طالما توفرت الإرادة والتزمت بالتقيد بالوسائل السلمية. كثيرا ما نسمع على ألسنة بعض النواب والكتل والأحزاب بأن السلطة التشريعية هي السلطة الأصلية بالمقارنة بالسلطة التنفيذية او القضائية وهذا في حاجة الى تدقيق شانه شأن عديد المفاهيم السياسية التي توظف قسرا وخطأ لتبرير السياسات. إن السلطة الأصلية تعود للشعب وللناخبين تحديدًا الذين يفوضون ممثليهم للحكم باسمهم وتبقى لهم الحرية المطلقة بأن يسحبوا هذه العهدة متى شاءوا وليس متى يسمح الساسة بذلك. وهذا ليس من باب الترف النظري او الفكري فقد عرفت الإنسانية عبر تطور ممارستها للخيار الديمقراطي مثل هذه السلوكيات وقد ذهب الأمر ببعض التجارب إلى حد سحب التمثيل النيابي من كل نائب خان أمانة ناخبيه باعتماد قوانين في هذا الغرض. ومن التصريحات الغريبة الصادرة عمن يعتبرون أنفسهم نموذجًا في الاستقامة والمواقف المبدئية من قبيل أننا باقون في الحكم طيلة كامل العهدة النيابية والى حين عقد الانتخابات العادية المقبلة وهو شكل من أشكال مصادرة حق الشعب في الاحتجاج والتغيير طالما توفرت موازين القوى ونضجت الظروف الموضوعية.
وليس خافيًا على أحد تنوع وتعدد الهويات والمشارب الفكرية والسياسية للجهات التي تقف اليوم وراء هذه الدعوات واختلاف المشاريع البديلة التي تنادي بها ولاندري إن كان هذا الأمر يمثل عنصر قوة او على العكس عامل ضعف قد يشتت جهودها ويسمح للائتلاف الحاكم باستغلال تناقضاتها الداخلية. ومن جهة أخرى وفي ظل تصاعد الصراعات داخل الأغلبية الحاكمة والتي تبدو اليوم غير منسجمة مع الأغلبية البرلمانية لا يستبعد أن تلتحق بعض مكونات الحكم إلى هذه الدعوات وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع واختلاط الأدوار.
إن الشرعية الانتخابية لا تعني مصادرة حق المجتمع المدني في الاحتجاج الحروالسلمي لفرض التغيير المطلوب في السياسات وحتى في الحكومات وقد ينجر عنه تغييرا في المسار الانتخابي بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها إذا ما سمحت به موازين القوى المتصارعة. قد يذهب الى أذهان البعض ان مثل هكذا تفكير هو أقرب منه للانقلاب على الشرعية أي عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات. وهذا في اعتقادي يعكس فهمًا تقنيًا وقانونيًا وإجرائيًا للمسالة الديمقراطية تجاوزه الزمن.
فقط على سبيل المثال لا الحصر كلنا يتذكر في أي ظروف سقط مشروع قانون العقد الأول الشغل في فرنسا على الرغم من مصادقة البرلمان عليه. إلا أن الاحتجاج السلمي والشعبي تمكن من الإطاحة به وإرغام السلطة للتراجع عليه نتيجة ميزان القوى الذي كان لصالح الشارع الفرنسي آنذاك والأمثلةعديدة.
ودون ان نقوم بالدعاية إليها فقط برزت في العالم المتقدم أصوات نخب فلسفية وفكرية وسياسية وان كانت لاتزال أقلية تدعو للعصيان المدني وعدم الانضباط للقوانين الجائرة والتمرد على الأنظمة التي تعتبرها لا تمثلها. ويمكن الإشارة في هذا السياق للتجربة التي لا تزال تعيشها فرنسا بعد ما يزيد عن السنتين والمتمثلة في السترات الصفراء. وكذلك تجربة ما يعرف بحركة السردينة في إيطاليا كرد فعل عن تنامي التيارات الشعبوية في الحكم. وعلى هذا الأساس فإنه لا يجب التسرع في الحكم على هذه الدعوات بالسلب او بالإيجاب. لأنها هي نفسها لم تكشف بالقدر الكافي على هويتها وأغراضها. فإذا ما تعلق الأمر بمبادرات سلمية هدفها التعبير على مواقفها من الوضع العام بالبلاد ومن السياقات السياسية الراهنة سواء تعلق الأمر بمسارات تشكيل الائتلاف الحاكم وكيفية إدارته لازمة الكورونا وطريقة تعامله بشؤون الدولة والمجتمع أوضاع التونسيين فهذا في اعتقادي لا يتعارض دستور البلاد وقوانينها. هذا على المستوى المبدئي لقط النظر عن وجاهة اختيار التوقيت من عدمه.
وقد يساهم هذا الحراك في عودة الروح للحياة السياسية ويحد من العزوف وهجرة الشأن العام. بقي على الذين تحمسوا لهذا الخيار ألا يصبون غضبهم على الأحزاب والشخصيات المتحفظة على توقيت هذا الحراك.
ان تعدد المواقع قد يفرض تعدد المواقف وربما توزيع الأدوار داخل المؤسسات وخارجها. ليس من النضج ولا من المسؤولية تضخيم الخلاف بين معارضي الائتلاف الحاكم بمجرد خلاف في تقييم ضرورة أو عدم ضرورة الانطلاق في الحركات الاحتجاجية منذ اليوم. وعلى المندفعين من أجل الإسراع بنصب الخيام والتجمعات وإعادة تنشيط الفضاء العمومي بنزول التونسيين إلى الشارع أن يتأكدوا من جاهزية المواطن واستعداده للانخراط في هذا الحراك. لان اي سوء تقدير لا يخدم قضاياهم العادلة والمشروعة. ومن جهة أخرى لا يمكننا إلا أن نستغرب ونستنكر السرعة الفائقة التي تميزت بها بعض أطراف الائتلاف الحاكم التي سارعت بإطلاق النار على مجرد تفكير اولي والدعوات أولية للنزول الى الشارع والاحتجاج السلمي وهو مايكفله الدستور معبرة عن انعدام كامل للثقافة الديمقراطية وحق الاختلاف والتنظيم والتظاهر. ومن نكد الدهر ان تصدر هذه المواقف من قوى وكتل نيابية محسوبة على الثورة والديمقراطية. ويبدو أن صعودها الى الحكم أفقدها صوابها وبدت عليها وفي خطاباتها مظاهر التسلط والهيمنة وحتى الفاشية. وللتذكير فإن أزمة الديمقراطية سابقة لازمة فيروس كورونا وأكيد أنها ازدادت عمقا احتداد وبالتالي علينا ان نراجع أنفسنا ومفاهيمنا حتى نستطيع فهم واستيعاب المتغيرات الحاصلة في التفكير السياسي نتيجة التقلبات التي تشهدها الإنسانية.
المنصف عاشور
ناشط سياسي مستقل









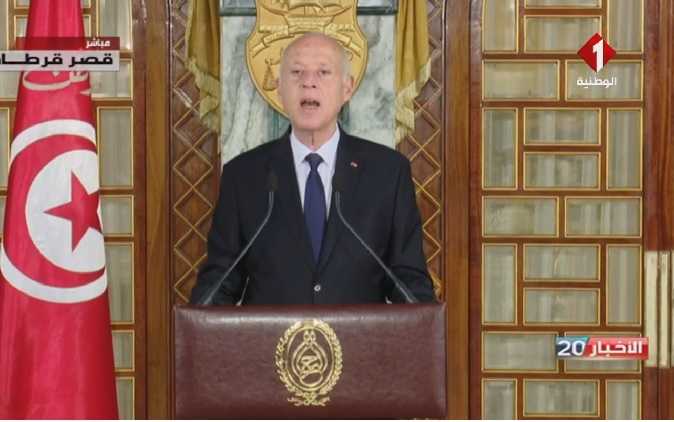






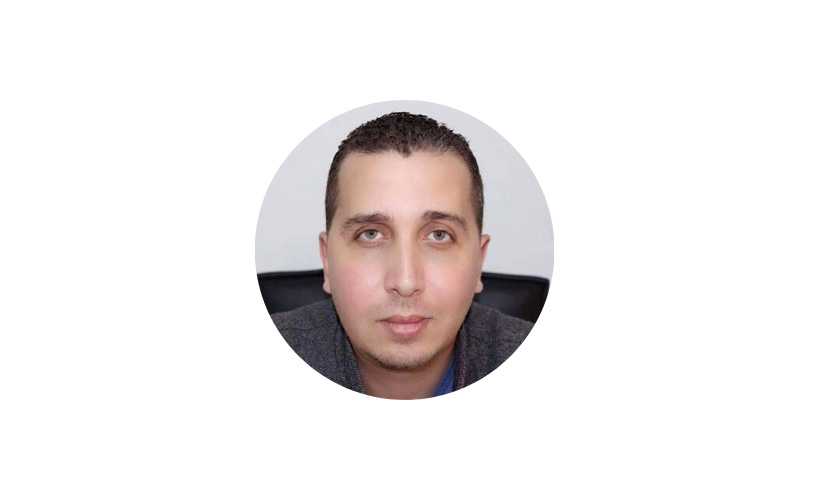


تعليقك
Commentaires